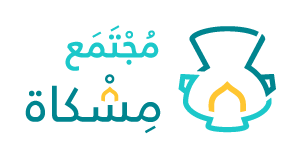حديقتنا السرية!
بسبب وفرة "حُزم الإنترنت" معي ولحنيني الجارف لأيام الطفولة القريبة بكل الأحوال! ، قررتُ في هذا الصباح (2019/1/7) أن أُشاهد على "يوتيب"، إحدى حَلقات فيلم الطفولة المُفضل لديّ "الحديقة السريّة"،ولم أستطع الإكتفاء بحلقة واحدة، بقيتُ لساعتين أُحدّق في شاشة هاتفي، كمن يُحدّق في جُرح. أيقنت حينها بأنني "أخاف" من تلك الحديقة السريّة!.
إنتشلتني تلك الحديقة من واقعي، وألقتني في أغوار الطفولة، لطالما كان الفيلم الذي يتحدث عن حديقة تختبئ مثل سر، مفتاحُ بابها ضائع وأسوارها عالية وصعبة، يدخلها طائرٌ أحمر، هو ذات الطائر الذي قاد الأطفال لإكتشاف الحديقة، كانت الحكاية بالنسبة لي فاتنة.. جميلة.. ومُؤثرة!. يا لها من قصة! قصة التعافي، التواصل مع العشب والماء والأرض والطيور والطين والورود، قصة "التغيّر"، من ألم الوحدة والقسوة، إلى جمال الوردة والشجرة! هي قصتي المُفضلة في الطفولة، وعلى ما يبدو ما زالت كذلك! "الحديقة السريّة" رواية الكاتبة الإنجليزية-الأمريكية فرانسيس هودغسون برنيت، تحكي عن جمال وروعة المعرفة والكشف، وأيضًا تتناول تقديس الأسرار وصيانتها، تُشبهنا تلك الحديقة السريّة، تُشبه على وجه الدقة تلك المنطقة البعيدة في أعماقنا، المكان الذي منه يُولد كل ما هو جميل ونحن بحاجةٍ ماسة لإكتشافه والإعتتاء به، تمامًا مثلما فعل الأطفال في الرواية/الفيلم. من وجهة نظري الشخصية، تتجسد حُبكة الرواية/الفيلم، بالطفل المريض، الذي تُرك بعد رحيل أمه تحت رعاية المُدبرة، المُدبرة "المُؤمنةُ جِدًا" بأن الطفل ضعيف ومريض ، رأته "مشروع أحدب ذا ساقيّن مُقوستين لن يحيا إلا قليلًا"، وبناءً على هذا الإيمان قامت بالتعامل معه، التعامل معهُ على نحو يجعله يُصدق بأنه ضعيف ومريض ومشروع أحدب لن يحيا كما الأطفال الآخرين..! جعلتهُ يُصدق بأن أشعة الشمس تُؤذيه، والجراثيم ما هي إلا وحوش تتربصُ به، وبأن التحرك من السرير ممنوعٌ عليه حتى ولو أدى ذلك لضمور جسده وتفتت روحه، شددت عليه "العناية الصحية"، حتى كادت تقتله، وفجأة ظهرت قريبته في حياته الصعبة، وعن طريقها أدرك بأن الخارج لم يكن مكانًا واسعًا ومليئًا بالجراثيم فقط!. بالتدريج، نجحت قريبته في إخراجه من السرير، من سجنه إن صحت العبارة، أصبحت تصحبه كندٍ لهُ، لا كمُحسنة إليه، ليلمس براحة يديه العشب ويستنشق الهواء ويشعر بأشعة الشمس ترتطم بجسده وتتسلل لأعماقه. إستطاعت أن تُساعده في تجربة المعرفة وحدة دون الإعتماد على الآخرين، وبالفعل نرى الطفل المريض والمُحتضر، يقفُ ويمشي على ساقيّه وهو في العاشرة من العمر.
إنتهى الفيلم بشكل رائع وجميل، ولم أستطع أن لا أتسائل: كم من البشر من حولنا يحيون حياة ذلك الطفل!؟ الطفل الذي غرسوا في ذهنه بأنه ضعيف ومريض حتى مَرض وأصبح ضعيفًا حقًا؟ الطفل الذي خبئوه عن الشمس والمعرفة والهواء، وأصبح يشعر بوجوده الهزيل واللامُجدي بسبب "الحقائق" التي كان الآخرون يفرضونها عليه؟ كم إنسان إستسلم بهذه الطريقة المُؤلمة لشخص آخر؟ كم مِنّا يحيا قي بيئات تُحاول إقناعه في كل يوم بأنه يحتضر بسبب مرضه؟ بأنه أحمق؟ وساذج وفاشل؟ مَن منا يستطيع التحرر من يد "المُدبرة" التي تُدمرنا وتقتلنا بإسم الحب والخوف؟ الجمال في القصة يكمُن في "حُب" الطفل للحياة بعد أن كان مُؤمن بأن الموت أقرب إليه منها. بحسب وجهة نظري، فإن القصص والروايات وجهٌ آخر للواقع المُعاش، لذلك فإن لكل واحد مِنّا أمل حقيقي ليس وهم، أملٌ بأن يتغيّر للأفضل.. بأن يمشي خطواته الأولى ولو بعد مرور عشر سنوات، أن يجد في مُحيطه شخصٌ ما.. قريبٌ لقلبه وروحه ليكون له عَونا لا أكثر.
#الخطاب_البديل